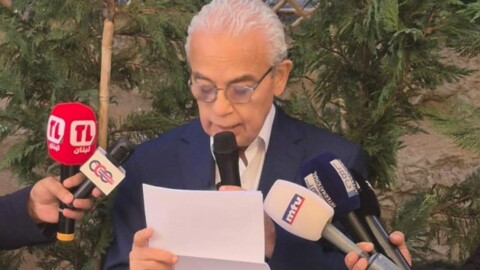إعداد د. محي الدين الشحيمي
مقدمة
في عصر التحول الرقمي، أصبحت إمكانات التشغيل البيني وتبادل البيانات في القطاع العام بالغة الأهمية لتعزيز الابتكار النظامي، وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز شفافية الحوكمة. يقدم هذا المحتوى استكشافًا شاملاً للآليات والأطر والتحديات والفرص المرتبطة بتمكين التشغيل البيني بين المؤسسات الحكومية. بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية، والهياكل التكنولوجية، والصكوك القانونية، واستراتيجيات إدارة التغيير، تتناول الدراسة دور حوكمة البيانات، وتوحيد المعايير، والتعاون بين القطاعات، والبنية التحتية الآمنة في كسر الحواجز التي كانت تعزل الإدارات والهيئات تقليديًا. كما تتناول المخاطر، والاعتبارات الأخلاقية، والعقبات التقنية التي تواجه نشر أنظمة التشغيل البيني. وتجادل الدراسة بأن أجندة تشغيل بيني متينة، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة، يمكن أن تؤدي إلى منظومات حوكمة أكثر تركيزًا على المواطن، وأكثر مرونة، وشمولية.
يعتمد تحوّل الإدارة العامة في العصر الرقمي على قدرة الجهات الحكومية على التواصل والتعاون والمشاركة في إنشاء الخدمات بفعالية. يتجاوز هذا المطلب الحدود التنظيمية التقليدية، مما يستلزم التكامل السلس وتبادل المعلومات بين الوزارات والدوائر والهيئات. أصبحت قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات، اللذان كانا يُعتبران في السابق مسائل تقنية، محورَ خطاب الحوكمة الحديثة. وهما أساسيان في تحقيق المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة والكفاءة والابتكار.
تتعرض مؤسسات القطاع العام عالميًا لضغوط متزايدة لتقديم خدمات أكثر انسيابية وفعالية من حيث التكلفة وتركيزًا على المواطن. ومع ذلك، فإن التقسيم البيروقراطي والمعروف باسم الصوامع، يعيق تدفق المعلومات، مما يؤدي إلى انعدام الكفاءة وتكرار الجهود وتحقيق نتائج عامة دون المستوى الأمثل. تُشكل مستودعات البيانات المنعزلة، والأنظمة غير المتوافقة، والأطر التنظيمية المتباينة تحديات كبيرة أمام قابلية التشغيل البيني.
استجابةً لهذه التحديات، أطلقت الحكومات طيفًا واسعًا من برامج التشغيل البيني ومبادرات تبادل البيانات. بدءًا من أطر الهوية الرقمية ووصولًا إلى سجلات البيانات المركزية وبوابات البيانات المفتوحة، تهدف هذه الجهود إلى إزالة الحواجز بين المؤسسات. وبينما حققت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، لا تزال دول أخرى تواجه تحديات جوهرية، مثل الأنظمة القديمة، ونقص التوحيد القياسي، والمقاومة الثقافية للتغيير.
تستهدف هذه العجالة تقديم دراسة شاملة للأبعاد النظرية والتقنية والمؤسسية والاستراتيجية، للتوافق بين الخدمات الحكومية في القطاع العام. وتهدف إلى تزويد صانعي السياسات وخبراء التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين بفهم شامل لكيفية مساهمة التوافق بين الخدمات، في تحفيز الابتكار النظامي وتعزيز الخدمات العامة الشاملة والفعالة والمستقبلية.
تتناول هيكلة هذا البحث المفاهيم الأساسية للتوافقية وتبادل البيانات، وتدرس أهميتها وتطبيقاتها في الحوكمة المعاصرة. وستستعرض الأطر القانونية والتنظيمية، وتُحلل البنى التكنولوجية، وتقدم دراسات حالة تجريبية من حكومات رقمية رائدة. بالإضافة إلى ذلك، ستبحث في الآثار الأخلاقية والأمنية والخصوصية لتبادل البيانات، مقدمةً منظورًا متوازنًا حول كل من الفوائد والمخاطر. وقد تمثل خارطة طريق استراتيجية ومجموعة من التوصيات العملية لتمكين إطار عمل مستدام وقابل للتطوير للتشغيل البيني في القطاع العام، مع التركيز على الحاجة إلى حوكمة تعاونية وبنية تحتية قوية وثقافة تكيفية موجهة نحو الابتكار.
المفاهيم والأطر والتعريفية
يتطلب فهم قابلية التشغيل البيني ومشاركة البيانات أساسًا مفاهيميًا واضحًا. تسند بالمصطلحات الأساسية وتوضح الإطر النظرية التي تستند إليها نقاشات الابتكار النظامية في القطاع العام، من خلال أنظمة المعلومات المتكاملة.
يشير التشغيل البيني إلى قدرة الأنظمة أو المؤسسات أو السلطات القضائية المختلفة على العمل معًا بسلاسة من خلال التبادل الفعال للمعلومات والاستفادة منها. وفي سياق القطاع العام، يشمل التشغيل البيني الأبعاد التكنولوجية والدلالية والتنظيمية والقانونية. فهو يُمكّن الخدمات والعمليات من تجاوز الحدود المؤسسية وإنشاء أنظمة حوكمة مترابطة.
ويُحدد الإطار الحوكمي للتشغيل البيني أربعة مستويات رئيسية للتشغيل البيني:
– التشغيل البيني التقني: يضمن توافق الأجهزة والبرامج وبروتوكولات الاتصال.
– التشغيل البيني الاستدلالي: يضمن الحفاظ على معنى البيانات المتبادلة وفهمها.
– التشغيل البيني التنظيمي: يُوازن بين العمليات التجارية ونماذج التعاون بين الكيانات.
– التوافق القانوني: يتناول توحيد التشريعات والأطر التنظيمية التي تحكم استخدام البيانات ومشاركتها.
تشمل مشاركة البيانات، نشرها وتسهيل الوصول إليها عبر الإدارات والهيئات والمستويات الحكومية. وهي تشمل بروتوكولات منظمة لمشاركة البيانات بشكل آمن وأخلاقي، وبما يحترم الخصوصية والقيود القانونية. وتُعد مشاركة البيانات ركيزةً أساسيةً للتوافق التشغيلي.
هذا ويشير الابتكار النظامي إلى التغيير التحويلي، الذي يؤثر على عدة مكونات للنظام في آنٍ واحد. في الإدارة العامة، ويعني ذلك إعادة صياغة كيفية تصميم الخدمات وتقديمها وتقييمها، بالانتقال من التدخلات المجزأة إلى مناهج متكاملة تشمل الحكومة بأكملها. وتُعدّ قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات بمثابة عوامل محفزة لهذا التحول من خلال إطلاق العنان لرؤى جديدة، وتحسين التنسيق، وتعزيز الإبداع المشترك.
تستند هذه الدراسة إلى نظريات متعددة، منها نظرية النظم، ونظرية نظم المعلومات، والنظرية المؤسسية. تُركز نظرية النظم على الترابط بين مكونات النظم البيئية المعقدة. تُركز نظرية نظم المعلومات على الديناميكيات الاجتماعية والتقنية التي تؤثر على كيفية تطوير أنظمة البيانات واستخدامها. بينما تُسلط النظرية المؤسسية الضوء على المعايير والقيم والهياكل، التي تُشكل السلوك والتغيير التنظيمي. ويمهد هذا الإطار المفاهيمي الطريق لتحليل متعدد الأبعاد، للتوافق وتبادل البيانات في الأقسام اللاحقة.
أهمية التوافق في الإدارة العامة
لا يُعد التوافق في القطاع العام مجرد متطلب تقني، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف الجوهرية للحوكمة الرشيدة، من حيث الاستجابة، والكفاءة، والشفافية، والابتكار. ومع تزايد عمل الهيئات الحكومية في بيئات معقدة ومترابطة، أصبحت القدرة على تبادل المعلومات آنيًا أمرًا أساسيًا لاتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات، وبناء ثقة الجمهور.
يتيح تمكين التوافق السلس لتقديم الخدمات، تقديم الخدمات العامة بطريقة متكاملة تركز على المستخدم. على سبيل المثال، يمكن للمواطن الذي يتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة والتأمين الصحي ودعم الإسكان، في أن تتم معالجة طلبه بكفاءة أكبر عندما تكون الأنظمة المعنية متوافقة. هذا التكامل يُلغي التكرار ويوفر تجربة خدمة متماسكة.
يمكن تعزيز عملية صنع القرار وصياغة السياسات، الأنظمة المترابطة الحكومات من تجميع البيانات وتحليلها عبر القطاعات، مما يُقدم رؤىً أغنى لوضع سياسات قائمة على الأدلة. على سبيل المثال، يُمكن لدمج بيانات التعليم مع إحصاءات التوظيف، أن يُساعد في تصميم برامج تدريب مهني أكثر فعالية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تساعد مقدرة تحفبز الاستجابة للأزمات والتنسيق، في حالات الطوارئ، كالكوارث الطبيعية أو الأوبئة، تُصبح قابلية التشغيل البيني أمرًا بالغ الأهمية. اذ يُتيح تبادل بيانات الصحة والنقل والأمن بين الوكالات في الوقت الفعلي، استجابات أسرع وأكثر تنسيقًا، مما يُسهم في إنقاذ الأرواح والموارد.
تتجلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة، في دعم التشغيل البيني مبادرات البيانات المفتوحة، ويُحسّن الرقابة من خلال تسهيل استرجاع المعلومات العامة والتحقق منها بسهولة. وهذا يُقلل الفساد ويُعزز ثقة الجمهور.
وتساهم الكفاءة الاقتصادية في تقليل تقليل تكرار جمع البيانات، وتمكين إعادة استخدام مجموعات البيانات الحالية من تكاليف التشغيل. كما يُعزز التشغيل البيني عائد الاستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعظيم فائدتها عبر خدمات متعددة. حيث يزيد الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص عندما تكون البيانات العامة متاحة وقابلة للتشغيل المتبادل، وتصبح موردًا للابتكار من قبل مطوري الطرف الثالث والأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، مما يعزز النظم البيئية الرقمية والتنمية الاقتصادية.
السياق التاريخي وتطور التوافقية
يُوفر فهم تطور التوافقية في الإدارة العامة سياقًا لتحدياتها الحالية وإمكانياتها المستقبلية. فعلى مدى العقود الماضية، تحوّل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحوكمة، من مجرد أتمتة أساسية إلى مُمَكِّن استراتيجي للإصلاح النظامي.
التحول الرقمي المبكر (ستينيات-ثمانينيات القرن الماضي): ركز الاعتماد الأولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام على أنظمة معزولة خاصة بكل إدارة، تهدف إلى أتمتة المهام الإدارية. افتقرت هذه الأنظمة إلى الترابط والتوحيد القياسي، مما أدى إلى وجود صوامع بيانات لا تزال قائمة حتى اليوم.
عصر الحكومة الإلكترونية (من تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين): بدأت الحكومات في تبني تقنيات الويب لتوفير واجهات رقمية للخدمات. ومع ذلك، ظلت هذه التقنيات ابتكارات واجهة أمامية ذات تكامل محدود مع الواجهة الخلفية. وبرزت الحاجة إلى التوافق التشغيلي نظرًا لأن قيود أنظمة المكاتب الخلفية المنعزلة أعاقت توحيد الخدمات.
الحكومة المفتوحة (2008-2015): مع صعود الويب ، تحول التركيز إلى الشفافية ومشاركة المواطنين والبيانات المفتوحة. وبدأ يُنظر إلى التوافق التشغيلي ليس فقط كضرورة تقنية، بل أيضًا كركيزة أساسية للحوكمة الديمقراطية والمشاركة المدنية.
التحول الرقمي والحكومة الذكية (2015 – حتى الآن): شهدت السنوات الأخيرة تحولاً نحو مناهج الحكومة الشاملة، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية. وأصبح التشغيل البيني محورياً في استراتيجيات التحول الرقمي الهادفة إلى إنشاء خدمات عامة ذكية واستباقية. كما يُنظر إليه على أنه أساسي للتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تُبرز الجهود الدولية في تحصين الاتجاهات العالمية الناشئة، مثل الإطار الأممي للتشغيل البيني، ومبادرة الأمم الرقمية، وأجندة البنك الدولي للتكنولوجيا الحكومية، إجماعًا متزايدًا على القيمة الاستراتيجية للتشغيل البيني. تُركز هذه الأطر على الوحدات النمطية، وقابلية إعادة الاستخدام، والتصميم المُركّز على المستخدم في بناء منصات حكومية رقمية مترابطة.
أنواع ومستويات التوافق التشغيلي
يمكن تقسيم التوافق التشغيلي في القطاع العام إلى أنواع ومستويات متعددة، يتناول كل منها بُعدًا محددًا من تكامل الأنظمة وتبادل المعلومات. ويعتمد نجاح تصميم وتنفيذ أنظمة التوافق التشغيلي، على إدراك هذه الأبعاد المتعددة ومعالجتها بشكل متماسك.
التوافق التقني: يُعد هذا الأساس للتوافق، ويشير إلى قدرة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات البرامج المختلفة على التواصل وتبادل البيانات واستخدام المعلومات المتبادلة. ويشمل توافق الأجهزة، وتنسيقات البيانات، وبروتوكولات الواجهة، ومعايير الاتصال.
حيث تشمل العوامل الرئيسية المُمكّنة للتوافق التقني ما يلي:
- بروتوكولات الشبكات المشتركة
- معايير ترميز البيانات
- واجهات التطبيقات
- منصات البرامج الوسيطة والتكامل
التوافق الاستدلالي: يضمن التوافق الاستدلالي الحفاظ على معنى المعلومات المتبادلة عبر الأنظمة. ويشمل ذلك مفردات وتصنيفات وأنطولوجيات وبيانات وصفية موحدة. على سبيل المثال، عندما تشير أنظمة معلومات صحية مختلفة إلى حالة طبية، يضمن التوافق الدلالي تفسيرها ومعالجتها بنفس الطريقة.
اذ تشمل الآليات الداعمة للتوافق الاستدلالي ما يلي:
- الأنطولوجيات
- المفردات المُتحكم بها
- سجلات البيانات الوصفية
- مبادئ البيانات المترابطة
التوافق القانوني والسياسي: حيث يضمن التوافق القانوني توافق تبادل البيانات مع القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة، في مختلف الولايات القضائية والقطاعات. وكثيرًا ما تُعيق قوانين حماية البيانات المتباينة، ولوائح الملكية الفكرية، وحقوق الوصول، تدفق البيانات بسلاسة.
وتشمل الاعتبارات الحاسمة ما يلي:
- مواءمة قوانين حماية البيانات (مثل: التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات)
- الاتفاقيات القانونية وعقود مشاركة البيانات
- آليات الامتثال وهيئات الرقابة
نماذج نضج التوافق التشغيلي: تستخدم العديد من الحكومات نماذج نضج التوافق التشغيلي لتقييم وتحسين جاهزيتها للتوافق التشغيلي. تُقيّم هذه النماذج التطور من تبادل البيانات العشوائي إلى منظومات رقمية متكاملة بالكامل. ومن الأمثلة على ذلك:
- نموذج نضج التوافق التشغيلي في القارة الأوروبية (EIMM)
- مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)
الأطر القانونية والتنظيمية
يعتمد التشغيل البيني الفعال على أساس قانوني وتنظيمي متين يوفر الوضوح والمساءلة والضمانات. فبدون تشريعات داعمة، قد يصبح تبادل البيانات غير متسق، أو غير مصرح به، أو محل نزاع. وتساعد التشريعات الوطنية وقوانين حماية البيانات الحكومات، على سنّ قوانين تُلزم وتُسهّل تبادل البيانات مع حماية حقوق الأفراد. ومن الأمثلة على ذلك:
- اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي
- قانون حرية المعلومات (FOIA) في الولايات المتحدة
- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في الهند
تُنظّم هذه الأطر:
- متطلبات الموافقة
- قيود استخدام البيانات
- تدفقات البيانات عبر الحدود
تلعب هيئات حماية البيانات والهيئات الحكومية الرقمية أدوارًا حاسمة، في فرض الامتثال وحل النزاعات وتوجيه الهيئات في تبني الممارسات المتوافقة. وتساهم قوانين الحكومة المفتوحة والوصول إلى المعلومات، في الزام هذه القوانين الجهات العامة بالإفصاح الاستباقي عن البيانات، مما يدعم الشفافية والمساءلة والابتكار. مع ذلك، يجب موازنة هذه القوانين بعناية مع قوانين الأمن والخصوصية.
تتطلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التوافق بين الأنظمة، عبر الحدود معاهدات وبروتوكولات تُوحّد المعايير والتفسيرات القانونية. ومن الأمثلة على ذلك:
- توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تعزيز الوصول إلى البيانات ومشاركتها
- اتفاقيات التجارة الرقمية الثنائية
وتعد العوائق والقيود القانونية من التحديات الشائعة، التي تشمل:
- تناقض القوانين بين الولايات القضائية
- متطلبات توطين البيانات
- الغموض في ملكية البيانات وإدارتها
نماذج واستراتيجيات حوكمة البيانات
تعتبر حوكمة البيانات الإطار الذي يضمن إدارة البيانات بفعالية وأمان وأخلاقية. وفي سياق التوافق التشغيلي، تُحدد حوكمة البيانات القواعد والأدوار والمسؤوليات، والإجراءات اللازمة لإدارة البيانات ومشاركتها. ومن أهم مبادئها الفعالة:
- المساءلة: ملكية واضحة ومسؤولية عن أصول البيانات
- الشفافية: سياسات مفتوحة بشأن الوصول إلى البيانات واستخدامها
- النزاهة: ضمان جودة البيانات ودقتها واتساقها
- الأمان: حماية البيانات من الوصول غير المصرح به والاختراقات
- الامتثال: الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية
تضمن أدوار إدارة البيانات القائمون على إدارة البيانات، تنظيم البيانات ومشاركتها واستخدامها بشكل صحيح. ويشملون:
- كبار مسؤولي البيانات
- أمناء البيانات (المديرون الفنيون)
- أصحاب البيانات (الجهات الفاعلة على مستوى السياسات)
وتشمل النماذج المعتمدة ما يلي:
- المركزية: تُخزَّن البيانات وتُدار مركزيًا، وغالبًا ما تكون من قِبل جهة واحدة.
- الفيدرالية: تبقى البيانات لدى الجهات المعنية، ولكنها تتبع بروتوكول مشاركة موحدًا.
- الهجينة: مزيج من البيانات الوصفية المركزية ومجموعات البيانات الفيدرالية.
تسهل في هذا السياق اتفاقيات وسياسات مشاركة البيانات، مع الأدوات الرسمية مثل اتفاقيات مشاركة البيانات، وتراخيص استخدام البيانات، ومذكرات التفاهم،على تسهيل تبادل البيانات بشكل متوافق وفعال مع القانون.
وتشتكل هذه الآليات المؤسسية على :
- المجالس الوطنية للبيانات
- فرق العمل المشتركة بين الوزارات
- مراكز تبادل بيانات القطاع العام
العوامل التكنولوجية المُمكّنة للتوافق التشغيلي
تلعب البنية التحتية الرقمية الحديثة، والتقنيات الناشئة دورًا محوريًا، في تعزيز التوافق التشغيلي في القطاع العام. فهذه التقنيات لا تُسهّل التكامل فحسب، بل تدعم أيضًا قابلية التوسع والمرونة والتركيز على المستخدم في الخدمات العامة. وتُمكّن واجهات برمجة التطبيقات الأنظمة، من التواصل من خلال عرض وظائف مُحددة للاستخدام الخارجي. وهي تُشكل العمود الفقري لمعظم المنصات الحديثة المتوافقة، مما يسمح بتبادل البيانات بشكل ديناميكي وفوري، وتكمن أهميتها في كونها:
- تُعزز واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة منظومات الابتكار بين القطاعين العام والخاص.
- تضمن واجهات برمجة التطبيقات الآمنة لآليات التحكم في الوصول والتسجيل.
هذا وتساعد حلول البرمجيات الوسيطة، بما فيها ناقل خدمات المؤسسة، على تنظيم التفاعلات بين الأنظمة المتنوعة من خلال ترجمة تدفقات البيانات وتوجيهها وإدارتها، مع مزايا بنية منفصلة، وتحكم مركزي، وتحمّل الأخطاء. حيث تدعم منصات السحابة الحكومية، بيئات البيانات المشتركة وقابلية التوسع والحوسبة المرنة، وهي أمور ضرورية للحلول القابلة للتشغيل المتبادل. وتتيح بحيرات البيانات والمستودعات الفيدرالية، في تخزين البيانات المهيكلة وغير المهيكلة لتحليلها عبر النطاقات. اذ تدعم المستودعات الفيدرالية وصولاً لامركزيًا وموحدًا، مع الميزات الرئيسية في قراءة المخططات، والاستيعاب الفوري، وتنسيقات جاهزة للتحليلات.
توفر تقنية البلوك تشين سجلات ثابتة وتحققًا لامركزيًا للبيانات، مما يعزز الثقة والقدرة على التدقيق في تبادل البيانات. وفي الوقت نفسه مع حالات الاستخدام، في سجلات الأراضي، وأنظمة المشتريات، والهوية الرقمية. حيث تضمن إدارة الهوية والوصول أطرعمل إدارة الهوية والوصول الفعالة الوصول الآمن إلى موارد البيانات عبر الأنظمة. مع المكونات المشابهة من تسجيل الدخول الفردي، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار.
تتيح أدوات اختبار التشغيل البيني، منصات المحاكاة ومواقع الاختبار للحكومات إنشاء النماذج الأولية واختبار حلول التشغيل البيني قبل النشر. وعلى الرغم من الجاهزية التقنية، فإن العديد من مبادرات التشغيل البيني تتعثر بسبب الجمود التنظيمي والمقاومة الثقافية داخل المؤسسات العامة. بالاضافة الى الصوامع التنظيمية والبيروقراطية، وغالبًا ما تعمل الوكالات بشكل مستقل مع تسلسل هرمي صارم. وتفتقر إلى الحوافز للتعاون بين القطاعات. مع مقاومة التغيير قد تؤدي قابلية التشغيل البيني إلى تعطيل سير العمل الحالي، مما يؤدي إلى إثارة المقاومة بين الموظفين العموميين.
يُفهم مصطلح التشغيل البيني عادةً في سياق البنية التحتية، أي كأداة لربط الشبكات. وبشكل عام، تُسهّل المعايير المفتوحة والأنظمة القابلة للتشغيل البيني الحياة وتزيد من الكفاءة.
يمكن تحديد وظائف التشغيل البيني على أربع طبقات رئيسية من تكنولوجيا الأنظمة المعقدة. القدرة على نقل البيانات والمعلومات الأخرى، وعرضها عبر الأنظمة أو التطبيقات أو المكونات؛ البيانات، القدرة على قراءة البيانات؛ العناصر البشرية؛ القدرة على التواصل، على سبيل المثال، من خلال لغة مشتركة؛ والجوانب المؤسسية؛ القدرة على العمل معًا.
يتناول التوافق القانوني عمليةَ تحقيق تعاون القواعد القانونية بين مختلف السلطات القضائية، على مستويات فرعية مختلفة داخل الدولة الواحدة، أو بين دولتين أو أكثر. ويعتمد تطبيق قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة أو إعادة تفسيرها لتحقيق هذا التوافق على الظروف المُحددة. في ضوء تزايد تشتت البيئة القانونية في الفضاء الإلكتروني، يجب بذل جهود لتحقيق مستويات أعلى من التوافق القانوني والسياسي لتسهيل التواصل العالمي، وخفض تكاليف الأعمال التجارية عبر الحدود، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي. كما أن القواعد القانونية المتوافقة تُهيئ بيئة عمل متكافئة للجيل القادم من التقنيات والتبادل الثقافي.
تعتمد درجة التوافق القانوني على القضية الجوهرية المطروحة. على سبيل المثال، تُعدّ القواعد القانونية المنسقة ضرورية لتطبيق نظام أسماء النطاقات؛ إلا أن الحاجة إلى توحيد أقل في مجال التعبير الثقافي. لذلك، تتناول هذه الدراسة الأسئلة التالية:
– ما أهمية التوافق القانوني وأوجهه في سياق حوكمة المفتوحة والإنترنت؟
– كيف يمكن تصميم مصفوفة من النماذج التنظيمية المتاحة في إطار حوكمة الإنترنت، وما هي جوانب التدخل التنظيمي التي يمكن تمييزها؟
– كيف يمكن استخدام التوافق القانوني الموضوعي كأداة لمكافحة التجزئة؟
يجب فهم العلاقة بين القانون والتوافقية كشبكة متعددة الاتجاهات. ينبغي أن يُمكّن التوافقية القانونية الأنظمة من العمل معًا، ولكن لا أن تجعلها متماثلة، إذ يمكن أن تكون المنافسة التنظيمية مفيدة ومثمرة شريطة أن يسود أفضل نظام معياري.
مع ذلك، لا ينبغي أن يكون التناغم التام هو النهج المُتبع في جميع الحالات، فمن جهة، لا يُمكن لمثل هذا الإطار أن يُراعي التنوع الثقافي للمجتمعات في عالم الإنترنت العالمي، ومن جهة أخرى، سيكون محض أمنية طوباوية في الواقع. علاوة على ذلك، من المهم إيجاد الدرجة المناسبة من التوافق القانوني (بدلاً من حل الكل أو لا شيء) مع مراعاة المبادئ الجوهرية (مثل حرية التعبير أو الخصوصية) في ظروف مختلفة.
يُعدّ التوافق التشغيلي أولوية قصوى اليوم، إذ تسعى الحكومات إلى دمج الخدمات بين مختلف الإدارات لتحسين الفعالية والكفاءة. يُعدّ التكامل الحكومي معقدًا، كما يتضح من معدل فشل المشاريع المُحبط. ومن الأسباب الشائعة لذلك عدم فهم العلاقات المعقدة بين الحكومة والمجتمع والتكنولوجيا، والتي تُؤثر في دمج العديد من المؤسسات، فهمًا كاملًا.
تسد هذه الفجوة من خلال دراسة مشروع تكامل وطني كبير، متسائلين عن طبيعة وأسباب النزاعات التي تظهر أثناء التنفيذ. فعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، شهد البحث في العلاقات بين الحكومة والمجتمع والتكنولوجيا نموًا ملحوظًا، لا سيما منذ طرح مفهوم الحكومة الإلكترونية، ولاحقًا الحوكمة الإلكترونية (EGov)، في أواخر التسعينيات. ومع ذلك، لا يغطي معظم هذه الأبحاث سوى فئات محددة بدقة، مثل التنظيم الحكومي، وخدمات المواطنين، والتوافقية، والخصوصية الشخصية.
يُمثل تركيز أبحاث الحكومة الإلكترونية التاريخية على الحكومة، وما يقابله من إهمال للحوكمة، مشكلةً متنامية، إذ يتجه تطبيق الحكومة الإلكترونية حول العالم نحو التكامل والتوافق التشغيلي. ويعني التكامل، بحكم تعريفه، إشراك المزيد من الجهات الفاعلة، وبالتالي التحول نحو الحوكمة. ويُظهر تاريخ الحكومة الإلكترونية عددًا كبيرًا من المشاريع الفاشلة، بل وحتى الفشل التام في بعض الأحيان. وغالبًا ما تُعزى حالات الفشل إلى تعقيد التكامل. ويؤدي فحص حالات الفشل السابقة إلى استنتاج مفاده أن التركيز على تكنولوجيا المعلومات كان مُضلِّلًا بشكل عام؛ إذ تُعتبر مشاريع الحكومة الإلكترونية، برامج تغيير رئيسية، ونادرًا ما تُخصص لـمشاريع تكنولوجيا المعلومات.
لقد وصلت الحكومة الرقمية إلى نقطة تحول. فبعد ثلاثة عقود من الزمن كانت فيها معدلات الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت أقل بشكل ملحوظ من معدلات اعتماد الخدمات التجارية وغيرها، حيث بدأ المواطنون ينظرون إلى الفضاء الرقمي، باعتباره نقطة التحول للتواصل مع الحكومة والقطاع والخاص والوصول إلى الخدمات الاجتماعية التي يحتاجون إليها.
خاتمة
يُعدّ تحسين التوافق بين الأنظمة والمفردات والمؤسسات أمرًا ضروريًا لمعظم المؤسسات العامة لتلبية احتياجات المستخدمين. وقد شكّل النمو السريع للإنترنت دافعًا قويًا لتوقعات المستخدمين وتمكين تبادل المعلومات بين المؤسسات. إلا أن نجاح مبادرات التوافق أمرٌ صعب، ومخاطر الفشل مرتفعة، ويعود ذلك غالبًا إلى ارتفاع التوقعات والاستخفاف بالتحديات الكامنة. فالعديد من مشاريع التوافق مُفرطة في المواصفات، ونتائجها لا تُنفّذ بالشكل المطلوب. حيث ينبغي قراءة تحديات التوافق في القطاعين العام والخاص بعناية، مع الدعوة إلى اتباع نهجٍ مُبسّط لتقليص الفجوة بين الخطط والواقع.
في العقود الأخيرة، استثمرت الإدارات العامة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث عملياتها الداخلية، وخفض التكاليف، وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. ورغم التقرب من القطاع الخاص، والتقدم الكبير المحرز والفوائد التي تحققت بالفعل، لا تزال الإدارات تواجه عوائق كبيرة أمام تبادل المعلومات والتعاون إلكترونيًا.
وتشمل هذه العوائق العوائق التشريعية، وعدم توافق عمليات الأعمال ونماذج المعلومات، وتنوع التقنيات المستخدمة. ويرجع ذلك إلى أن أنظمة المعلومات، تاريخيًا، كانت تُنشأ في القطاع العام بشكل مستقل عن بعضها البعض، وليس بطريقة منسقة. ويضيف تنوع التكوينات المؤسسية عبر مختلف القطاعات مستوى آخر من التعقيد على مستوى. حيث يُعد التشغيل البيني شرطًا أساسيًا لتمكين التواصل الشامل وتبادل المعلومات بين كل من الإدارات العامة والقطاعات الخاصة. وهذا يجعله أيضًا شرطًا أساسيًا لتحقيق سوق رقمية موحدة.
وقد تطورت برامج التشغيل البيني عالميا بمرور الوقت. في البداية، كانت معنية بتحقيق التشغيل البيني في مجالات محددة، ثم بإنشاء بنية تحتية مشتركة. بدأت في الفترات الأخيرة في معالجة التشغيل البيني على المستوى الدلالي. وتعتبر الحوكمة، وتوافق الأنظمة القانونية، ومواءمة العمليات التجارية، والوصول الآمن إلى مصادر البيانات بعض القضايا التي يتعين معالجتها في المرحلة المقبلة، لتوفير الخدمات العامة بشكل كامل