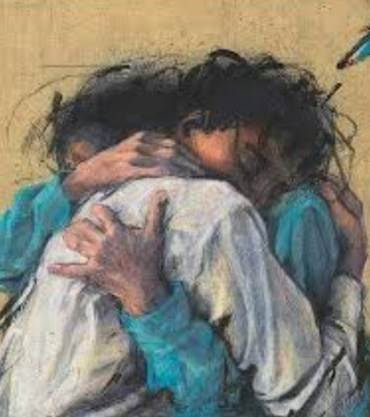الدكتور جورج كلاس/ النهار
لعل أكثر القضايا إشكالاً في الواقعية اللبنانية ، ان فيها فائض من السياسة و قليل من المواطنة . و ينسحب ذلك على بنية و اهداف الخطاب السياسي في مظهريه الشعبي و الإعلامي ، كما على اتباع و مريدي المرجعيات و الزعماء والقادة و رؤساء الاحزاب الفاعلة و ذات الحضور الوطني و الشعبي .
إن اكثر الأمور إستغراباً في حمّى حرب المصطلحات و المزايدات السياسية التي تستعر في لبنان اليوم ، بعد التحولات التي عرفتها المنطقة ، تتجسد في ما تشهده الساحة اللبنانية من إستعراضات سياسية و مبارزات كلامية ، بين سياسيين و اصحاب مشاريع تغييرية و هواة و إندفاعيين و مبتدئين طامعين لأخذ دور ما ، مما يعكس تشظياتِ و إنقساماتٍ حادة بين المكونات المجتمعية عمودياً و أُفقياً ، في اكثر أوقات البلد سخونة و أدقها حراجة . و هذا ما يُبرز اختلافات حادة في تضارب المفاهيم و تباينات في الولاءات ، و توزُّعاتٍ تناقضية ، بين مَنْ يُعلِنُ مشروعاً للبنان جديد و يتنكُّر قصداً او عن جهل صريحٍ لمعنى لبنان و كيانيته ، و بين من يطرح أنماطا تجريبية للحكم و انظمته ، تقوم كلها على تسليع شعارات مُجمَّلةٍ بمصطلحات تسويقية تغلّف كل مصطلح بدلالته التشريعية و معانيه الإنقلابية صداها أعلى من صوتها الأمر الذي يفسر ان النظام المعتمد حالياً يحتاج إلى تحديث و تطوير هاديء بعيدا عن الإستهداف و الانفعال ، من دون أن يكون لهذا النظام المُصوَّب عليه من المنتفعين و المحظيين و الطارئين ، حماةٌ يدافعون عن روحيته و يحصنون ميثاقيته و يزعمون قيمته كقانون اساسي ناظم لمسار الدستور و حماية كيانية الوطن ، حيثُ أرسى اتفاق الطائف قاعدة مفهومية توافقية شكلت منطلق السلوك السياسي للجماعات اللبنانية في خيارها التوافقي و مسارها التوفيقي ، بما يؤكد الكيانية النهائية للبنان ، إستلهاماً من روحية كلام للإمام موسى صدر ، الذي لا يزال صوته صدّاحاً منذ خمسين سنة ، تاريخ الحرب على لبنان ، و لا اقول الحرب الاهلية أبدا، لانها ليست ذلك على الاطلاق .
و في الزمن الذي تستعر فيه حرب العراضات اللفظية و تتعاظم المزايدات السياسية بين القوى القادرة و محترفي الإطلالات المنبرية و الهواة التجريبيين تحديدا، ، تنقسم الاراء و تتشظى المفاهيم طبقاً لولاء و إنتماء كل فريق وفق التزاماته و تعهداته و مغامراته ، بعيداً عن مدى صوابية رؤيته و مسؤولية طرحه و انعكاساته على المعنى الكياني و الدور الحضاري و التركيبة المجتمعية للوطن القائم على نموذجية التعدديات الطائفية التي توافقت دستوريا و تفاعلت ميثاقياً لتأسيس الكيان اللبناني السيادي و تحصين نمطه الفريد و رعايته اللحظية و المستدامة ، مخافة تصدع الركائز التي بني عليها.
ان عملية رصد الرؤى و متابعة البيانات السياسية التي تحدد مواقف المرجعيات الوطنية كمحترفي سياسة و مسؤولين ، و تتابع بدقة مواقف الكتل النيابية و الاحزاب ، و تقارنها مع الإعلانات الشعبوية الرافعة شعارات لا إقناعاتٍ لها ، تظهر بوضوح خطر الشروخات الفهمية التي تشيع في الإعلام و تنعكس قلقاً على الناس ، نظراً لتضاريها مصطلحياً و لغوياً ، و لخروجها عن مسار التوافق الميثاقي الذي بني عليه لبنان ، بصيغته الفريدة ، و رسالته الانسانية و دوره الحضاري .
فثمة فئة واعية من السياسيين الكيانيين ذوي الواقعية التفكيرية و الحريصين على روحية الدستور، تؤيد اتفاق الطائف صراحة و تثق بإنقاذيته للوضع و تدعو إلى إستكمال تطبيق بنوده حتى يصلح الحال و تنتظم الأمور و تسود العدالة الدستورية بأبهى تجلياتها . و ثمة فئات اخرى تطرح موضوع تعديل الطائف ، من دون ان تعرف كل مضامينه و لا تدري اي شيء عن روحيته و أبعاد مضامينه، بحيث أمسى الكلام عن هذا الاتفاق الذي إستحال دستوراً للبلد ، اشبه بمنصات لاطلاق خطاب المزايدة ، أو بسطات للعرض و بضاعة للإستهلاك اللفظي و استغلال المناسبات او ( هايد بارك ) استعراضي مفتوح للمزايدات و تجارة الكلام و توظيفات المواقف غب الطلب . إلى جانب جماعة تطالب باعتماد اللامركزية الموسعة و توسيع صلاحياتها ، من دون أي ادراكٍ مفهومي لمفاهيم اللامركزية و القوانين الناظمة لها و من دون أي تَحسُّبٍ لما قد يستتبع ذلك من انعكاسات على الواقعين السياسي والشعبي .
و تترافق هذه المواقف الكثيرة الرؤوس و العديدة الألسن بإحتفاليات مهرجانية لجماعة تطالب بالفيدرالية ، كنموذج إستقلالي مقنّع مبني على مخاوف و تبريرات، من دون أي ارتكاز جغرافي او اقتصادي او ديموغرافي يير. او يساعد على الإقتناع بفضائل الفدرالية و الإقناع بضروراتها الموجبة ، بما يشي بأن القصد من كل هذا الصراع بين سياسيين و محترفين او هواة ، هو التنكر للنظام الحالي و استهدافه ، رغبة بالتغيير و الانتقام من وضع سائد و ليس قناعة صلبة بمستلزمات كل طرح . بالمقابل تتصدى قوى أخرى للوضع السياسي القائم من باب الاتهام الاعمى و تطالب بالعلمنة الشاملة للدولة بالمعنى الواسع للعلمنة ، و ذلك رداً على طرح مبدأ إلغاء الطائفية السياسية. و هذا ما يؤشّر إلى تباعدات بين القوى و الاحزاب و الجماعات على مستوى المفهوم و الطرح و متابعة تدَرجيَّةِ للمفاهيم و المنطلقات في مجتمع نموذجي معرَّض لتشظياتٍ نزاعية حادة على الواقع الداخلي و التفكير الافتراضي .
و السؤال المحوري في عملية التطوير الدستوري و التنمية القانونية للدولة ، هو : أي دور للمثقف اللبناني في إطلاق المبادرات و ادارة النقاش السياسي الواعي حول نزاع المصطلحات و اخطار انعكاساتها ، أمنيا و أخلاقيا و تضامنياً ؟ و لماذا إنكفاؤه عن إعلان موقفه و بيان رأيه الصريح ، و إختباؤه من تقديم إجابات صريحة على هذا السؤال الوطني الكبير ؟
اما الاخطر ، فهو التغاضي القصدي عن التفكير بواقعية لطرح الدولة المدنية ، كمشروع إنقاذي من مخاطر جادة و حادة يتعرض لها الوطن . فهل مفهوم الدولة المدنية ، يولد مخاوف و يخلق حساسيات ؟ ام انه طرح عقلاني و عملاني و واقعي ، بحاجة إلى من يرفع رايته بمسؤولية و يسوقه بإقناعية و يستثمر إيجابياته ، و إلى مَنْ يشرح فوائده و يدافع عن القيم التي تعكسها روحية الدولة المدنية بأبعادها الدستورية و معانيها الحضارية ، و إبراز محاسن حمايتها للخصوصيات ، و فضائل تحصينها لثنائية الانتماء و الإلتزام ،و طمأنتها للمواطنين ، ان لا للإستئثارية و لا تحكم للغلبة العددية ، بل الإحتكام إلى منطق العدالة الواقعية في فهم الواقع و إدارة الذات الجماعية للخلاص من مخاطر النزاعات و اخطار النزاعات ، بعيداً عن المزايدات في بازار السياسات .
فهل تكون الدولة المدنية هي الحل الامثل و الأقرب تطبيقا للواقع اللبناني؟
و من يكون عرّاب هذا المفهوم الانقاذي الذي يقي الوطن إنزلاقات واهية ؟