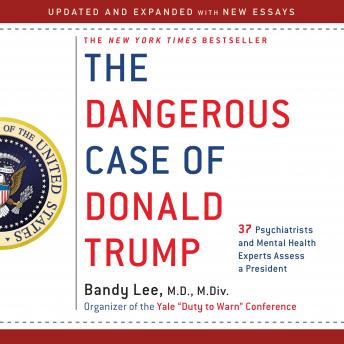المهندس ساسين القصيفي
إنَّ بنيانَ كلّ كيانٍ، شَخصيٍّ او مَعنويٍّ او ثقافيٍّ او سياسيٍّ، يَرتكزُ إلى عِدَّةِ طبقاتٍ من الهُوّيَّاتِ، تتداخلُ فيما بينها، لتكوين الشخصيَّة الحقيقيَّة له.
في الغربِ، ومَعَ انتشارِ العلومِ والفَلسَفَة، المُنبثقَتَيْنِ عنِ المَوْجاتِ التَّنويريَّةِ المُتلاحقةِ، عَبْرَ عِدَّةِ قرونٍ، والتي غَلَّبَتِ المنطقَ التَّجريبيَّ، في مَناحي الحياة، راكمَت هذه المُجتمعاتُ، رصيدًا إنسانيًّا ساميًا أخلاقيًّا، حَرَّرَ الفردَ والمجتمَعَ من كثيرٍ من المُثقِّلات التي كانت تَكْبَحُ تَجرُّدَهُ. وقد تَخَطَّت هذه المُجتمعاتُ، مفاهيمَ الدَّولةِ الوطنيَّةِ للقرنِ التاسِعِ عشرَ، والتي كانَت قائمةً على أسُسِ العِرقِ او القوميَّة اوالدِّين… وذهبت بعيدًا في تنويعِ مَفاهيم الرَّكائِزِ الهُوِّياتيَّةِ الحَداثيَّة للدَّولةِ، فباتت شُرعَةُ حقوقِ الانسان الدوليَّة، والدِّيمقراطيَّةُ والحداثةُ، مع ما يواكِبُها، من ترسانةِ حُرِّيّاتٍ فرديَّةٍ، وانتظامٍ وشفافيَّةٍ في المؤسَّساتِ العَّامَّةِ، أساسًا لِثقافَة المُواطَنَةِ الدَّولَتِيَّةِ ذاتِ الهُويَّةِ الحَديثةِ.
بينما في الشَّرقِ، فما زالَ مفهومُ الدَّولة – الأمَّةِ، بِمَعناها الدِّينيّ او المَذهبيِّ، هو الأساسُ الطَّاغيُ، على دساتيرِ ومؤسَّساتِ الدُّوَلِ وَوَعْي شُعوبِها، والتي تُصَدِّرُ دساتيرَها، بأنَّ دينَ الدَّولةِ هو الإسلامَ، أو أنَّ الشَّريعَةَ الإسلاميَّةَ، هي المصدَرُ الاساسُ للتَّشريعِ. فتَجَمَّد الفِكرُ النقدّيُّ، وتنَمَّطَ الإعلامُ المُجتَمعيُّ، وتسطَّحَت أراءُ المُثقَّفين، فتراجَعت مصادرُ المَعرفةِ، وضاقَت مساحةُ الحريَّةِ، وسادَ الركودُ البحثيُّ، فآلت هذه المجتمعاتُ، الى ركيزةٍ هُوِّياتيَّةٍ مُنغلِقةٍ وَأحاديَّةٍ، عِمادُها المفاهيمُ الدِّينيَّة.
التجاربُ التاريخيَّةُ أثبتَت، أنَّ كلَّ حضارةٍ إتَّكأتِ على ركيزةٍ واحدة، وسَوَّرت نفسَها بستارٍ حديديٍّ، بحيث حرَّمَتِ التَّفاعُلَ، انتهت الى الذُّبُولِ العَقَائديِّ والفناءِ الحضاريِّ. وآخرُ الأمثلةِ، المَنظومةُ الشُّيوعيَّةُ، ودُوَلُ ذَوَاتِ الغَلَبَةِ الدينيَّة او العقائديَّة. فيما كلُّ حضارةٍ، تَوَكَّأت على عدَّةِ ركائز، وتفاعَلَت مُنفَتِحَةً مع علومِ وفلسفةِ العصرِ، ولم تَخشَ الآخرَ، ازدهَرَت مجتمعاتُها، وارتقَت بالبشريَّةِ الى مرتبةٍ أعلى، واستمَرَّت بتَجدِيدِ دورِها وثَقافتِها وفلسفتِها لفتراتٍ طويلةٍ، مثلَ الحضاراتِ الإغريقيَّةِ والفرعونيَّةِ والرُّومانيَّةِ…والغربيَّةِ حاليًّا.
وهكذا كانت أيضًا لفترةٍ مُحَدَّدَةٍ، بغدادُ العبَّاسيِّين ودمشقُ الأمَويِّين، الحاضرتانِ اللتَانِ ابتَغَتَا العِزَّةَ، بتلاقُحِ الأفكارِ ونَشرِ الثقافةِ والعلومِ، حيثُ كانتا مُتَعدِّدَت الثَّقافاتِ، ومُختَلَطَت الأعراقِ، وذي اتِّجاهاتٍ فكريَّةٍ مُختلفةٍ، الى انْ سيطرَت الأحاديَّةُ العَقَائديَّة، وذلك ليْسَ بِدءًا بِفِقْهِ ابن تيْميَّةِ وتلاميذِهِ، والتي أفضت الى منهجيَّةٍ جامدةٍ في الزمنِ، استمرَّت وتأصَّلت مَع تواتُرِ هُوِّياتِ الحاكمِ من مماليك وعُثمانيِّين، وصولًا الى الفِكرِ الوَهَّابيِّ والسَّلفيِّ والإخواني والإرهابيِّ، مع ابن لادن والبغداديّ… فَأَخَذَت حواضرُ هذا الاقليمِ، بالتوازي مع تلك الفترةِ، تنحَدِرُ في تَّقَهقُرٍ حَضَاريٍّ وإنسانيِّ، في سقوطٍ حرٍّ، الى يومنا هذا!
خلالَ وبعدَ ثوراتِ الرّبيع العربي، بانَت عوارضُ الخَلَلِ المُجتمَعي بِشَكلٍ واضحٍ، حيث فُقدَ التَّوازُنُ في المؤسَّساتِ العَّامَّة، فاندلَعَت حروبٌ إقصائيَّةٌ، بين الهُوِّيَّاتِ الدينيَّةِ والمَذهبيَّةِ والعِرقيَّةِ… فاهتزَّت الركيزةُ الوطنيَّة ذاتُ الهُوِّيَّةِ الدِّينيَّةِ، فسقطَت الكياناتُ في أتونِ حروبِ الهُوِّيَّاتِ المذهبيَّة والعِرقيَّةِ، مع لَفحَةٍ من ثأرِ التَّاريخِ الدَّامي.
والسؤالُ الأبرزُ،
لماذا يترافَقُ تأكيدُ الهُويَّةِ الذاتيَّةِ، عند البعضِ في هذا الإقليمِ، مع فكرةِ إلغاءِ الآخر؟
ولماذا يَغيبُ او يُغيَّبُ النقاشُ المَوضوعيُّ، في مساحةِ التَّماسِ، بينَ مُكوِّنَاتِ الهُوِّيَّةِ المَوروثَةِ، ومُؤثِّراتِ تَحديَّاتِ العالمِ الحديثِ؟
كتَبَ ابن خلدون يومًا: أنَّ الثابتَ الوحيدَ في علمِ الاجتماعِ، هو التَّحوّلُ الدَّائمُ.
فحبَّذا لو تسيرُ هذه الشعوبُ، بأفكارِها ومصالحِها، بطريقٍ إرتِقائيٍّ، قبلَ أن تَخرَبَ البصرةُ، مرَّتيْنِ بصورةٍ ثوريّةٍ.