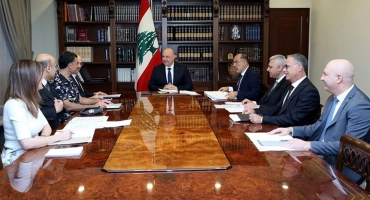اعتماد وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، الدكتورة ريما كرامي، لجدول تعليمي يقوم على أربعة أيام تدريسية أسبوعياً شكّل خطوة غير مألوفة في تاريخ النظام التربوي اللبناني.
القرار جاء في وقت حساس يتسم بتحديات اقتصادية ومالية وإدارية خانقة، ما يضعه تحت دائرة نقاش واسعة حول جدواه وقدرته على الصمود.
خلفيته المباشرة تعكس سعي الوزارة إلى التكيف مع ضغوط الموارد البشرية والمالية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول نوعية التعليم، ومستقبل الأجيال، وتأثيره على البنية الاجتماعية.
على المستوى التعليمي، لا شك أن تقليص أيام التدريس يثير قلقاً مشروعاً من حيث تراجع التحصيل العلمي. فالمناهج المعتمدة في لبنان مكثفة، صُممت لدوام كامل يمتد خمسة أيام. تكثيف المواد في أربعة أيام قد يؤدي إلى ضغط إضافي على التلميذ والمعلم معاً.
صحيح أن هناك إمكانية لتعويض ذلك عبر اعتماد طرائق تدريس حديثة كالعمل بالمشاريع والتعلم المدمج، لكن ذلك يتطلب تحضيراً لم يحصل بعد. تجربة فنلندا مثلاً أظهرت أن خفض أيام التعليم لا يؤثر سلباً على النتائج إذا ترافق مع تطوير المناهج ومرونة الأساتذة، لكن الفارق أن هذه البلدان استثمرت سنوات في بناء أرضية متينة لمثل هذه الخطوة، فيما يجد لبنان نفسه مضطراً لاعتمادها كحل ظرفي.
في البعد الإداري، تطبيق النظام الجديد سيضع المدارس أمام اختبار حقيقي. الحديث عن دوامين صباحي ومسائي يعني الحاجة إلى بنى تحتية صلبة، من كهرباء ومياه وتجهيزات صفية، وهي غير مضمونة في كثير من المناطق. كما أن المناقلات التي أُنجزت بين الأساتذة قد تساعد في إعادة توزيع الموارد البشرية، لكن غياب التخطيط الواضح قد يخلق فجوات بين مدرسة وأخرى.
في هذا الإطار يبرز دور النظار وأمناء والأساتذة الاحتياط اذا وجدوا، الذين غالباً ما ينظر إليهم على أنهم عناصر ثانوية، لكنهم قد يتحولون اليوم إلى ركيزة في استمرارية العملية التعليمية إذا مُنحوا الدور المناسب.
الأثر الاجتماعي لا يقل أهمية. قرار كهذا قد يخفف بعض الأعباء المالية عن الأسر، خاصة في كلفة النقل والطعام، لكنه في الوقت نفسه يفرض على العائلات تحدياً جديداً في إدارة وقت أبنائهم في يوم العطلة الإضافي.
في ظل اقتصاد مأزوم، قد يجد بعض الطلاب أنفسهم منجذبين إلى العمل الجزئي أو الأنشطة غير التعليمية، مما قد يزيد من احتمالات التسرب، خصوصاً لدى الفئات الأكثر انكشافاً.
هنا يطرح السؤال: هل يتحول اليوم الخامس إلى فرصة لتوسيع التعليم غير النظامي والأنشطة الثقافية والفنية بالشراكة مع البلديات والجمعيات، أم يصبح مساحة فراغ تعمّق التفاوت الاجتماعي؟ تجارب دول مثل بعض المقاطعات في كولورادو بالولايات المتحدة أظهرت أن الأسبوع التعليمي القصير يمكن أن يخلق وفورات مالية ويوفر وقتاً للأهالي، لكنه قد يفاقم التباين بين المناطق الغنية والفقيرة.
أما البعد السياسي فلا يمكن إغفاله. النقابات التعليمية، التي لطالما كانت لاعباً أساسياً في رسم معالم السياسات التربوية، قد تنظر إلى القرار بريبة إذا لم يتم إشراكها في صياغته. أي شعور بالتهميش قد يقود إلى إضرابات جديدة تزيد الوضع تعقيداً. لكن من ناحية أخرى، إذا قُدّم القرار كجزء من خطة إصلاحية شفافة تراعي ظروف المعلمين والطلاب، قد يسهم في خلق مناخ استقرار نسبي ينعكس إيجاباً على العام الدراسي.
هنا تكمن أهمية بناء توافق وطني حول التعليم باعتباره ركيزة أساسية للخروج من الأزمة. من الطبيعي أن تثير هذه الخطوة تساؤلات وهواجس، لكنها في الوقت نفسه قد تمثل فرصة لإعادة التفكير في النموذج التعليمي برمته. إن تقليص أيام التدريس لن ينجح بمفرده من دون مراجعة المناهج، وتدريب المعلمين، وتأمين الحد الأدنى من البنية التحتية. كما أن دمج التعليم النظامي مع نشاطات غير صفية في اليوم الخامس قد يحوّل التحدي إلى مساحة إبداعية. لبنان يحتاج إلى سياسات تعليمية تراعي ظروفه الاستثنائية، لكنه أيضاً يحتاج إلى جرأة في الإصلاح. القرار الحالي قد يكون بداية نقاش جدي حول مستقبل التعليم، وما إذا كان قادراً على أن يتحول من عبء إضافي إلى فرصة لإرساء نموذج أكثر مرونة وعدلاً.
بيروت يا بيروت